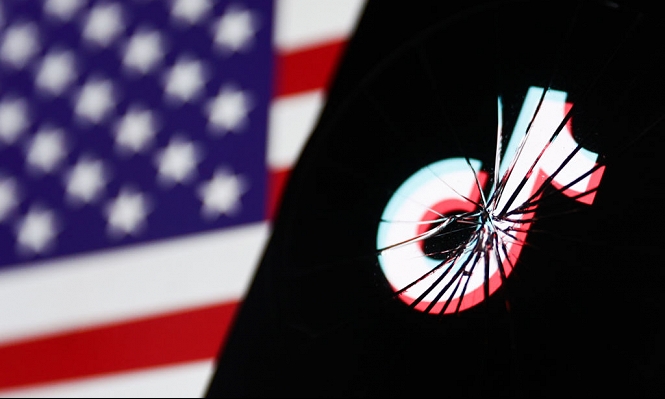أن يتفرّقوا | نصوص

حمزة
النسيم يشقّ طريقه في الهواء رغم الحصار، والسماء صافية زرقاء، لكنّ هذا لن يغيّر أيّ شيء، ما عدت أرتاح لما تقوله سماء صافية زرقاء، الهاتف يرتجّ في جيبي، الروح ترتجّ في الصنم الّذي أعيش فيه. ما الّذي سأفعله في الستّين ثانية القادمة؟ كيف سأخبرهم أنّ جيش الاحتلال سيقصف البيت؟ لا هاتف في منزل العائلة، ولا إيمان يكفي ليوقظ النيام على الجبل إن صرختُ بأسمائهم من بعيد، لا آلة للتخاطر أستخدمها فتُنْجي أبطال قصّتي من نيّة القصف الوشيك.
إنّها الشدّة، اليد الّتي تنسلّ إلى صدرك من فتحة في القميص... ثمّ تعصر القلب.
الفقد الّذي يفجّر عاطفة المشاهدين من عيونهم في نشرة الأخبار.
أمّي تقرأ وردًا من القرآن في هذه الساعات، أبي على الأرجح يأخذ قيلولة بين قيلولتيه، أختي تربط حجابها حتّى لا تنكشف بغير قصد على رجال الإسعاف والمنقذين... غاية ما أتمنّاه الآن ألّا يفزعهم الجيش بصاروخ تحذيريّ ينبّئهم بقدوم ملك الموت خلال دقيقة واحدة.
على القصف أن يكون سريعًا ودقيقًا ودون مقدّمات، وعلى العائلة أن تفعل ما تفعله العائلات في غزّة طيلة أيّام الحرب:
أن يتفرّقوا.
وتنفَلِتَ أشلاؤهم
في الريح
مثل بذور الهندباء.
* استخدم جيش الاحتلال الإسرائيليّ منذ العام 2006 وحتّى آخر حرب شنّها على غزّة في عام 2014 ما يعرف بالإنجليزيّة Roof knocking، وهو أسلوب هجوم صاروخيّ يرمي - كما يدّعون - إلى تحذير سكّان المبنى المستهدف بضرورة إخلائه خلال دقيقة واحدة، الأمر اّلذي أدانته منظّمات حقوق الإنسان حول العالم والكثير من وسائل الإعلام.
ما يفعله الصاروخ التحذيريّ في الحقيقة هو القتل، وإن لم يتمكّن من ذلك فهو يضع بين يديك حقيقةً مفادها: ستموت؛ خلال ستّين ثانية.
يتّصل - في بعض الحالات - أحد أفراد جيش الاحتلال بأحد سكّان المبنى المنويّ قصفه ليخبره بضرورة إخلاء البيت، وهو ما حدث مع حمزة هنا، إّلا أنّه لم يكن هناك، ولم يستطع إنذار أهله لأنّهم لم يشحنوا بطاريّات هواتفهم بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، وضع الهاتف في جيبه، وجثى على ركبتيه، ثمّ نظر إلى الأعلى.
***
رسالة
الضحكات الّتي أحببتها منك لم تكن مرّة لي أو معي، والحبّ الّذي كان يفيض عن روحي في وجودك ضاع، والذكريات الّتي بيننا ممحاة من فحم تسوّد صفحة حاضري البيضاء، الخيانة منك لا تحمل المعنى الّذي ينخز القلب في المسلسلات، إنّها الخيانة الّتي يعقبها صمت طويل، صمت طويل وتامّ، بلا اجتهاد موسيقيّ حزين، أو تكاليف إنتاج.
إنّها الخيانة الّتي تبهتُ وجه من وثق بك، والخذلان الّذي يُسقِطُ جسدًا أحبَّك عن صهوة آمنة، وانعدام الثقة في الوعود والكلام الّذي يتبع أيّ قسم.
ما الّذي يدفع رجلًا وَلَدَتْه حبيبته وضمّته تسع سنين إلى صدرها... ما الّذي يدفعه إلى الخيانة؟ كيف تهرول قدماك إلى أحد غير الّذي حَبوَتَ إليه، ومن ذا الّذي سيقنعني أن ألوم فتاةً أسالت لعابك رغم كلّ الّذي ربَّيته فيك وخسرته من كلس عظامي عليك.
أترك لك رسالتي، وأترك لك البيت، وأترك لك القاهرة، وأتوقّف عن عطائي. أعلم علم اليقين أنّ مثلك يندمون، وحتّى ذلك الحين، لن تجد لي مكانًا ولا رقم هاتف تتبعه، ولا أثرًا لأملٍ يدلّك عليّ.
لياليك الواعية آتية لا محالة. سينسلّ البرد مثل مرض خبيث إلى خلاياك الّتي تبعتْ رغبة التنويع، وستعود إليّ...
ستعود
وستدرك
منذ اللحظة الّتي ستلتقي بها عينيك
في عينيّ
أنّه:
لم يعد في الحنايا مأوىً لكلب ضالّ...
* وُجِدَت هذه الرسالة في ليلة ماطر، مطويّة بعناية، وملقاةً قرب باب أحد مقاهي رام الله. أصابت الرسالة شهرة واسعة بعد أن نشرتها الفتاة الّتي وجدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، لم تُعرَفْ كاتبة الرسالة حتّى الآن، كما لم يُعرَفْ الشابّ المعنيّ بالرسالة، لكنّ الرسالة اشتُهِرَتْ بـ «رسالة إلى كلب رام الله».
***
عبد الرحيم الحاجّ صالح
للناس أسباب تجعلهم قادرين على النهوض كلّ يوم من جديد، للصباح تأثيره السحريّ على الهمم، وللّيل ما يُفهم من إسدال الستار في المسرحيّات، لقد فقدتُ أسبابي، وتملّكتني طاقة هائلة على اليأس صرت عبدًا لها، ووصلني من إسدال ستار اليوم مفهوم النهاية لا فكرة الفصول.
لقد هزمتني الحياة وجرّدتني أدواتها،
بقيت وحدي، لا أحباب، ولا كرامة في طريق المحاسيم، لا طموح ولا مدى، لا ضوء في نهاية النفق إلّا الّذي ما انفكّ يضيء كلّما نفخ الموت في فحم العائلة.
لقد أخذت من الغرب احترام المغادرين لهذه الدنيا، وأخذت من «مجلس الأمن» وعودًا ماتت كلّ عائلتي في انتظارها، وأخذت من الاستبشار قدرته على نكث الوعود، ومن العزيمة ما يدخل قبّعة الساحر ثمّ يخرج على هيئة آلام وجروح.
لقد كان لي - في بيتنا - أسباب كثيرة للعيش دُفِنَتْ تحت جنازير جرّافات جيش الاحتلال الّتي هدمت البيت.
ولا قدس في عيون «منظّمة التحرير»، لا قداسة إلّا لتنسيقها الأمنيّ.
لقد انتهى كلّ شيء.
ليست لديّ طاقة أصرفها في ضبط النفس، كلّ ما أحتاجه اليوم هو توفير ما ظلّ من أمل في حصّالة الرّحيل، عليّ أن أملأ هذه الروح بيقين يرى في دفن البذور فكرة جديرة بالتطبيق، فكرة ترى في الإيناع احتمال الحدوث، وترى بإنهاء الحياة شكلًا من أشكال ابتدائها.
يبدو أنّه من الصعب أن تنتمي لأرض مقدّسة دون أن تكون قربانًا لها.
لكنّني لن أغادر وحدي، سآخذ أكبر عدد ممكن من الّذين كانوا سببًا لذلك.
* عبد الرحيم الحاجّ صالح (٢٠ عامًا) أب لطفلين، دُفِنَ في قريته جنوب جنين بعد أن أَقْدَمَ على طعن ثلاثة من جنود الاحتلال على حاجز أمنيّ بين مدينتين في الضفّة الغربيّة قبل أن يتمكّنوا من إطلاق النار عليه.
* استنكر رئيس السلطة الفلسطينيّة آنذاك عمليّات الطعن ضدّ جنود الاحتلال، وألحقها باعتذار رسميّ.
***
نادر العاني
حبيبتي،
أكتب كلّ ما في خاطري وأرسله إليك رغم معرفتي بانقطاع الكهرباء، وبأنّ محاولاتي المتكرّرة للعودة إليك تشبه محاولات المصالحة بين «السلطة الفلسطينيّة» و«حماس»، أنا إيمان على بساط ريح، يوصلني إليك الخيال، مدركًا أنّ الحقيقة لا تعمل في حضور المجاز، وأنّ إغماض عيني عن الواقعيّ لا يفتح المعابر.
لكنّني لا أريد التصديق بكلّ هذا.
إنّني لأفضّل أن أعيش عامًا كاملًا دون نهار، ليالٍ لا تسطع شمس فيها، وأن يجثو عام من الأسى على ركبتيه فوق عظامي...
أفضّل كلّ هذا على أن تتركيني.
أفضّل حربًا من جديد أموت فيها عدّة مرّات على أن تسقط أحلامي مثل شنّارة شاحبة في فخّ الحصار.
أفضّل العيش في غزّة على أن أتذكّر ما قلته لي عبر «سكايب» في لقائنا الأخير.
يا لكلامك القاسي، يا لوجهك الملبّد بالغيوم، يا لسواد عينيك اللّتان تدّعيان البراءة، كيف صارتا نقطتان من نفط ثقيل؟
إنّني
لا شِعر يسعفني
ولا دموع
إنّني...
لا أستطيع الارتماء أمام باب بيتكم كما يفعل السكارى في شاشة التلفاز، لا أستطيع إضرام نار قرب بيتكم في الخليل، ولا أستطيع اتّباعك حيث تذهبين أو رمي الحجارة على شباكك العالي، لا شيء أستطيعه سوى الكتابة لك منذ الآن حتّى تعود الكهرباء، علّ ما بكيته هنا على دفعات، يذيب قلبك حين تقرأينه دفعة واحدة.
أحبّك، نادر العاني- غزّة.
* قالت له اقتباسًا من الغابة النرويجيّة:
"علينا أن نكون جريئان بما يكفي لنودّع بعضنا".
* يعيش نادر في غزة، وتعيش حبيبته في الخليل، هذه واحدة من عدّة رسائل بعثها بالتسلسل ذاته، الظروف المكرّرة ذاتها لعدّة فتيات تركنه منذ شنّت إسرائيل حرب عام 2006 على القطاع وحتّى يومنا هذا.
* يستخدم نادر هذه الرسالة كنموذج استجداء، يغيّر اسم الفتاة ومكان سكنها مع كلّ فتاة جديدة ينوي استعطافها، ومن ثمّ استغلالها إن أمكن.
***
سلام
كنت بلا قدرة على امتصاص الحزن، أنا الآن أنتجه.
الصمت بلاغة الجوّ بعد الكارثة، حديقة العائلة بلا ورود، والسعادة في البعيد، أحفورة في حقبة الديناصور، إخوتي أشباح شاحبة، أمّي دمعة لا تجفّ وأبي أكفّ لا تحيد عن الدعاء.
أنا مثل كلّ الصامدين في الأراضي المحتلّة عام 1948، أكره الاحتلال والليل اللّذين سلباني أخي، البكاء منفسي الناضب والوحيد، أحفظ هذا السمّ في صدري، صدري كهف ينقّط فيه الحزن وأسمع في القاع صداه.
محمّد، كان اسمه محمّد، كان بسملة في سورة العائلة، ويدًا حنونة، فَتَحَ الباب على الليل وأغلقه على الرجوع، راح إلى حيث الأصدقاء يذيبون البرد بالنار والنكات، لكنّه لم يعد، ولم تعد روحي الّتي طلَعتْ حين صرختُ في وجوه الأطبّاء: "أريده كاملًا".
فؤادي فارغ، ويئنّ، كالخلخال في رجل الحمام.
* اخترقت الرصاصة رأس محمّد على إثر خلاف بسيط نشب بينه وبين أحد أصدقائه في أحد تجمّعات العرب في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948، واّلتي يسهّل الاحتلال دخول الأسلحة والمخدّرات إليها.
نَقل رجل خمسينيّ محمّد إلى المشفى بسيّارته، والّذي فُوجِئَ هناك باتّصال يؤكّد أنّه أب القاتل. طالب الأطبّاء العائلة بنقله إلى مستشفى آخر أكثر تخصّصيّة، وحين قرأت أخته أوراق النقل وجدت بينها موافقة على التبرّع بأعضائه. عَرَضَ أهل القاتل مالًا رفضه أهل محمّد، وأصرّوا على ضرورة إجلاء عائلة القاتل من الحيّ، الّذين رفضوا بدورهم الجلاء، إذ: أين يمكن للناس أن يرحلوا في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948؟ وبقيت العائلتان متجاورتين في الحيّ ذاته.
كُتِبَتْ هذه القصة بعد سنتين على الحادثة، بعد يومين على رؤية سلام لأخيها الأصغر وهو يخبّئ سلاحًا في غرفته.
***
لارا
أنا... لساني سوط يلسع في فمي حين ألفظ اسمي، والليل غراب يرقد على ناظريّ في وَضحَ النهار، أحبّ الناس، أحبّ اللون في الأشياء... والأشياء، أرتعش حين يمرّ الحبّ بي مثلما تمرّ الريح من حضن السروة العالية.
بلى، وبي من الجنون ما يجعلني ألعق الموسيقى عن الآلات، وأستطيع أن أحوّل النقود الّتي أجنيها من العمل إلى عطور، وأن أخلق مستقبلي ممّا يراه حدسي، ومن صوتي آنية للعطش، غيّرت حياة الكثيرين، أسعدتهم دونَ أن أضرّ أحدًا، لكنّني لم أتمكّن من إسعادِ نفسي، يداي زعنفتان، أجدّف بهما في بحر يموج في زجاجه المكسور، قلبي صَدفة ناشفة، وصوتي ينحني حين يطل برأسه.
من لولب التجاويف.
لا مال ينقصني ولا محبّين، بل يزيد، وأعدّ أيامي مثل الخراف على تلّ الوسن، تنقصني المهارة في إفراز السيروتونين، ما يجعلني بعيدة عن الغرف المكتظّة بالناس، والناس.
تطبيقات المحادثة عن طريق الكتابة سهّلت تواصلي مع الناس. وصوتي الّذي في اتّجاه واحد لا أحبّ سماع صداه.
أُعطي كما يعطي المحبّون، وأتلقّى الضربات كما يفعل كيس مشنوق في النوادي الرياضيّة.
أنا حزينة
وهذه الحال ليست إراديّة يا حبيبي.
وحدي، والموسيقى... والقليل من الكلام.
* لارا واحدة من أهم الفنّانات في فلسطين، تقرأ كما لو أنّها تعيد خلق النصوص من جديد، وتعيش في اللغة؛ كأنّها مفرد يُستَدلُّ به على الجموع.

كاتب فلسطينيّ أردنيّ يعمل أخصّائيًّا تربويًّا في دبيّ، حاصل على جوائز عربيّة ومحلّيّة منها «جائزة ملتقى الإعلاميّين الشباب العرب» (2009)، و«جائزة مؤسّسة محمود درويش» (2015).